غراميات شارع الأعشى
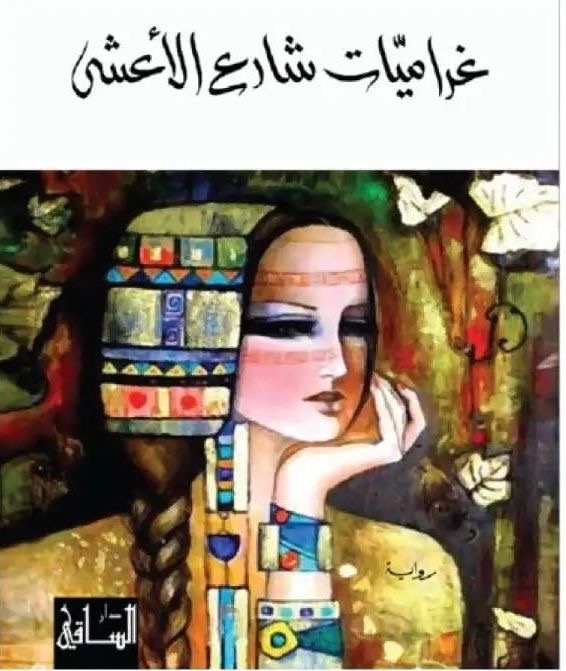
محمد النجار
بين الحب والحداثة والمجتمع: تأملات في رواية غراميات شارع الأعشى
تأخذنا الكاتبة بدرية البشر في رواية "غراميات شارع الأعشى" إلى رحلة هادئة في زمن كانت فيه التفاصيل الصغيرة قادرة على صناعة دهشة كاملة. زمن لا تُقاس فيه السعادة بضجيج الإنجاز، بل بلحظة دخول جهاز تلفاز ملوّن إلى بيت متواضع، أو برنين هاتف يعلن اتصالًا نادرًا بالعالم. مشهد دخول التلفاز والهاتف إلى بيت أبي إبراهيم لا يبدو تفصيلاً عابرًا في السرد، بل علامة فارقة على تحوّل اجتماعي بطيء، تتسلل فيه الحداثة إلى البيوت على استحياء، وتعيد تشكيل الحساسية الإنسانية تجاه الزمن والعلاقات والمعرفة.
في هذا السياق، تأتي قصة الحب بين سعد وعواطف بوصفها احتجاجًا صامتًا على إيقاع العاطفة المعاصرة. حبٌّ يقوم على الشوق والانتظار والحرمان، لا على السرعة والامتلاك. كأن الكاتبة تلمّح، من بعيد، إلى أن العاطفة حين تُحاصَر وتُؤجَّل، لا تذبل بالضرورة، بل قد تزداد صفاءً وعمقًا، وتتحول إلى ذاكرة حيّة تسكن الوجدان طويلًا بعد أن تخفت وقائعها.
وتبرز شخصية عزيزة بوصفها إحدى أكثر الشخصيات ثراءً دلاليًا في الرواية. فتاة متمرّدة تحاول أن تكتب نصّ حياتها بيدها، وأن تخرج من الهامش الذي رسمه لها المجتمع. غير أن الرواية لا تقع في وهم البطولة السهلة؛ فمحاولة التجرّد الكلي من العادات والتقاليد لا تمرّ بلا ثمن، وغالبًا ما يكون هذا الثمن صدمات موجعة وكسورًا داخلية لا تُرى. وإلى جانب ذلك، تؤدي عزيزة دور «الراوي الإطاري»، ذلك الصوت الخفي الذي يرافق القارئ من الداخل، يفسّر، ويعلّق، ويكشف الطبقات النفسية للشخصيات من غير مباشرة أو تقرير. هنا لا نقرأ الحكاية فحسب، بل نشارك في تأويلها، ونغدو جزءًا من وعيها السردي.
أما وضحة، فهي التجسيد الأكثر قسوة لوجه المجتمع حين يسلّم أطفاله إلى المصير بلا حماية. زواج القاصرات هنا ليس فكرة نظرية، بل جرح حيّ. فتاة أُلقي بها في تجربة تفوق قدرتها، ثم تُركت بعد أربعة أبناء تواجه الحياة وحدها. دخولها شارع الأعشى لم يكن اختيارًا رومانسيًا، بل ضرورة وجودية. ومن خلال مسيرتها الشاقة، ترسم الرواية صورة مؤلمة لقوة المرأة حين تُدفع إلى الحافة، وحين لا تجد في العالم سوى ذراعيها لتتوكأ عليهما.
وعلى الرغم من أن معظم الخيوط السردية جاءت محبوكة بوعي ودقّة، فقد بدا لي أن الكاتبة كانت أكثر قسوة مما ينبغي على شخصية أبي إبراهيم. هذا الرجل المتفهم، المنفتح، القادر على موازنة القيم القديمة مع تحولات زمنه، كان يستحق نهاية أكثر دفئًا، أو على الأقل أقل فجاجة في قسوتها. وكأن الرواية هنا آثرت الواقعية الصارمة على العدل العاطفي، واختارت أن تقول إن الطيبة وحدها لا تحمي أصحابها من خيبات العالم.
ومن الإضافات الذكية في النص إدراج حادثة اقتحام الحرم، ذلك الحدث الذي ظلّ في الذاكرة العامة محاطًا بالغموض أو التبسيط. الرواية لا تستحضره بوصفه واقعة تاريخية فحسب، بل باعتباره لحظة مفصلية في الوعي الجمعي السعودي، لحظة كشفت هشاشة العلاقة بين الدين والحداثة حين تُدار بعقلية الصدام لا التفاهم. هنا تطرح الرواية سؤالًا فكريًا عميقًا: هل نحن أمام تناقض جوهري بين الإسلام والحداثة، أم أمام سوء إدارة للانتقال بين زمنين؟ سؤال لا تجيب عنه الرواية مباشرة، لكنها تتركه معلقًا في ذهن القارئ، بوصفه أحد أسئلة الحاضر المستمرة.
ولا تخفي الرواية انحيازها الواضح لإنصاف التجربة الأنثوية. النساء هنا لسن ظلالًا على هامش الحكاية، بل مركزها العاطفي والأخلاقي. لهن مشاعر معقّدة، ورغبات مؤجّلة، وأحزان صامتة، تمامًا كما للرجال. والرسالة الضمنية واضحة: لا يمكن لمجتمع أن يدّعي تماسكه الأخلاقي وهو ينكر إنسانية نصف أفراده، أو يحاصر مشاعرهم باسم الحماية والوصاية.
في المحصلة، خرجت من غراميات شارع الأعشى وأنا مأخوذ بسرديتها السلسة، وتشويقها الهادئ، وقدرتها على الجمع بين الحكاية العاطفية والتحليل الاجتماعي والتساؤل الفكري في نسيج واحد متوازن. إنها ليست رواية عن زمن مضى بقدر ما هي مرآة ناعمة لتحولات مجتمع، ودعوة مفتوحة للتأمل في علاقتنا بالحب، وبالحداثة، وبالإنسان حين يكون في أضعف لحظاته… وأصدقها.














