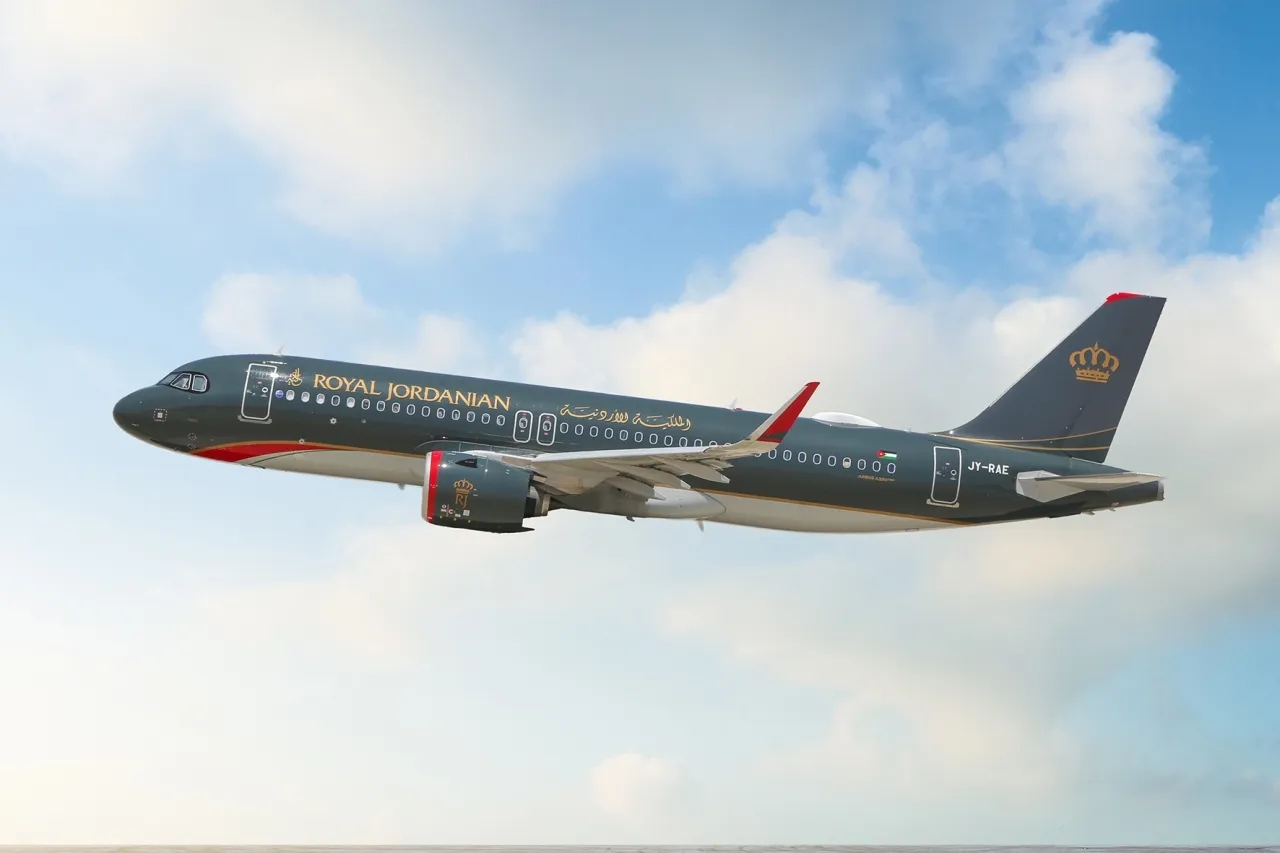الشريط الإخباري :
بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق يوم 8 مارس/آذار من كل عام، أعاد مهرجان ليدز للسينما الفلسطينية عرض الفيلم الفلسطيني «ملح هذا البحر» Salt of This Sea للمخرجة والشاعرة الفلسطينية آن ماري جاسر. الفيلم إنتاج مشترك صدر عام 2008 ورشح لجائزة الأوسكار عن فئة الأفلام الدولية، كما نال عدداً من الجوائز في مهرجاني ميلانو ودبي، وغيرهما. قام بأداء الأدوار الرئيسية فيه الممثلة الفلسطينية الأمريكية سهير حماد بدور «ثريا» والممثل الفلسطيني صالح بكري بدور «عماد».
العودة والحق
على الرغم من أن موضوع الفيلم ينهض على موضوع العودة الذي يبدو مشتركا في أكثر من عمل سينمائي فلسطيني، غير أن ما يميز هذا الفيلم منظوره الإخراجي، خاصة النظر إلى تكوين فلسطين عبر وعي الأجيال، التي نشأت بمعزل عن إدراكها لفلسطين ضمن التصور المادي المعاين، مع محاولة نسج صيغة خطابية تستدعي إعادة محاولة تعريف فلسطين لدى الأجيال التي نشأت خارج فضائها، حيث يثقلها وعي التهجير والمنفي. وإذا كانت المخرجة آن مارس جاسر قد ركزت على تحرك الكاميرا عبر معاينة مدن فلسطينية كرام الله والقدس ويافا وحيفا وغيرها، فإن حبكتها بدت مفارقة للنموذج المستهلك لبعض الأفلام، في قراءة الجدلية بين الفلسطيني ووطنه المستلب، حيث يغرق الكثير من الأعمال أحياناً بتفعيل النموذج الطوباوي المباشر، والاستهلاك لبعض النماذج الأيقونية: كالتراب، والشجرة، والمفتاح، ورثاء الذات بوصفها نماذج حوارية غير فاعلة؛ ولهذا ارتأت المخرجة أن تجعل سياقات الفيلم قائمة على حدث غريب، بالتجاور مع لمسة هادئة أو رومانسية تؤطرها علاقة «ثريا» المولودة في نيويورك بعماد الشاب الفلسطيني الذي يعمل نادلاً في أحد المطاعم.
تعود ثريا إلى فلسطين بداعي المطالبة بميراث جدها من البنك البريطاني، لمبلغ قدره (150) جنيهاً فلسطينياً، كان في حساب توفير جدها عام 1948. تبدو لنا ثنائية عماد وثريا إطاراً جمالياً ينضح بما هو إنساني، ومع ذلك فقد بدت لنا هذه العلاقة مكوناً خصباً لبناء المسرد الرمزي والحكائي والأيديولوجي، على الرغم من أن القصة قد تبدو في بعض الأحيان متعالية في غرابتها، أو لا واقعيتها، لكنها تمكنت بطريقة ما أن تشحن المشاهد بطاقة حيوية، وأن تجعله يغرق في ما يمور بعقل هذين الشابين، وصديقهما الثالث (مروان) حين قرروا استعادة مال «ثريا» عبر سرقة البنك الذي أنكر ميراث الجد بحجة ضياع كل شيء، فتنشأ فكرة السطو بعد طرد ثريا وعماد من عملهما في المطعم لتهجمهما على بعض اليهود، وهكذا يتمكنان من سرقة ( 15 ألف دولار وسنتين)، وهو إرث جدها مع الفوائد، ومن ثم يهربان من رام الله إلى داخل الكيان الإسرائيلي، أو الداخل لمشاهدة مدينة القدس ويافا وحيفا ومعانقة بحر فلسطين في مشهدية بدت لي على قدر كبير من الإتقان على مستوى التحفيز العاطفي، عبر أداء مزج بين شعرية الأداء، وتمظهر الأيديولوجية.
تسعى المخرجة إلى تجسيد خطاب سينمائي قوامه، إن فلسطين في وجودها الكلي، وهويتها ستبقى في وعي شعبها، والأهم أنّ الأرض تدرك ذاتها، بغض النظر عن محاولات محو تعالقها مع أصحابها الأصليين.
لم تظهر فلسطين سواء أكانت الضفة الغربية أم الداخل، ضمن عملية تطرية أو تجميل، لقد بدت فلسطين كما هي، وكما رصدتها الكاميرا، فظهرت حيوات الفلسطينيين في الضفة، كما هي بلا إضافات: بفوضاها، وحزنها، وفرحها وتناقضها، هكذا يسعى الفيلم إلى أن يؤطّر مفهوم العودة، ونقد الكيان الغريب عند عودة ثريا، ولاسيما وصولها إلى فلسطين، مع التركيز على عملية الاستجواب والتفتيش الدقيق، والاستفسار عن مكان الولادة، ووجود جواز سفر آخر، لينتهي الفيلم في بناء دائري على وقع الأسئلة عينها عند ترحيل ثريا، لكن مع إجابات مغايرة، أو بلغة تتعإلى على المفاهيم السياسية والقوانين، وما يمكن أن يقال عن هراء تفاهمات السياسيين.
تسعى المخرجة إلى تجسيد خطاب سينمائي قوامه، إن فلسطين في وجودها الكلي، وهويتها ستبقى في وعي شعبها، والأهم أنّ الأرض تدرك ذاتها، بغض النظر عن محاولات محو تعالقها مع أصحابها الأصليين. ولعل في إنكار البنك لأموال جدها بسبب الفوضى، وضياع البلاد، ينطوي على دلالة بأن هذا التنافر بين المفاهيم، أو لنقل بين التفسيرات لا يبدو مقنعاً، فثمة خطاب الوعي بالمكان من لدن الذات والتاريخ، مقابل وعي المؤسسة أو الخطاب السياسي، وهكذا تتخذ المؤسسة المالية بطابعها الرأسمالي نطاقاً رمزياً، فهي تبقى قائمة ككيان، لكن تضيع حقوق البشر؛ ولهذا يأتي فعل السرقة بوصفه تمرداً على تفاهمات المؤسسة أو السلطة، التي تبدو خاضعة لإملاءات مخجلة من الكيان الصهيوني، كما يتضح من لقاء ثريا بمسؤول السلطة الفلسطينية، وعجز الأخير عن تقديم تفسيرات منطقية يكاد يماثل عجز «أبو الخيزران» في رواية «رجال في الشمس» لغسان كنفاني
شاعرية الاستعادة
هكذا تمضي بنا آن ماري جاسر في خطابها السينمائي الذي يتوج جمالية المسلك الأيديولوجي، ويخفف من حدته بعلاقة الثنائي ثريا وعماد الحالم بالهجرة إلى كندا للدراسة، والمتبرم من وجوده في سجن كبير، فنقرأ في تقاطع هذا الثنائي، نوعاً من الانسجام كما تفعيل الطاقة الإيجابية لعلاقة حب صامتة، أو لا تبدو مفتعلة أو صاخبة، إنما هي عفوية وتلقائية جداً، كما هي أفعال هذا الثنائي حين يغرقان في عناق شعري مع مدن فلسطين، فتذهب ثريا لزيارة بيت جدها، وهناك تواجه من تسكنه، ونعني امرأة يهودية سلبت المكان وذاكرته، في استدعاء لأجواء رواية «عائد إلى حيفا» لغسان كنفاني، إذ تتيح السيدة اليهودية لهم الدخول والبقاء لفترة على هامش حوار ينشأ لدى المجموعة، ينتقد السياسيين الذين يرفضون إحلال السلام، لكن ثريا سرعان ما تستعيد متخيلها للمكان، وتستشعر حضور أسلافها فيه، أو روحهم، فتسأل عن الأثاث وسبب اختفائه من المكان، فتنفجر في وجه السيدة اليهودية طالبة منها الاعتراف بأن هذا البيت يعود لجدها، وتطالبها بالرحيل، وهكذا تنشأ مفارقة مصدرها الحوار مع اليهودية التي تتهم ثريا بأنها شخص يعيش في الماضي، وبأنها معتدية، وعليها الخروج من المنزل، فتستدعي الشرطة لطرد المتطفلين الذين تعاملت معهم بلطف، حين سمحت لهم بالدخول إلى بيتها، أو (بيتهم ـ بيت جد ثريا).
اتقنت المخرجة تعميق مشاهد للبحر ببلاغة مشهدية، كما استطاعت أن تخترق وعي المشاهد، لتحميله طاقة انفعالية عميقة، فلا جرم في أن يطرح سؤال الشخصيات عن شعور الأنا، وهي تعود إلى المكان أو فلسطين؟
تستند المخرجة في صيغتها إلى ثلاثة عناصر أهمها: سيناريو متقن ينهض على تشييد العلاقة مع المكان الذي يعد العنصر الثاني في الأهمية، ولا سيما من حيث تمكين المشاهد من رؤية فلسطين من زاوية بصرية أرشيفية، لا تخلو من شعرية مقتصدة، أو متوازنة، وهنا نلمح توظيف المشاهد وتقنية الألوان التي تبدو في بعض الأحيان مغرقة في واقعيتها، حيث تبدو فلسطين كما هي لا تخضع لأي تعديل، فنرى مناخها الصحراوي واخضرارها، كما عمق تاريخية المكان، وما طرأ عليه من تشويه طارئ، فتسرقنا الكاميرا لنمضي في معاينة التاريخ، وآثار الذين رحلوا، كما نرى القدس من زوايا متعددة نتيجة اختيار زوايا النطاق للكاميرا، وهذا ينسحب على يافا وحيفا، والأهم أن حركة العدسة تجعلنا نستغرق في مشاهدة البحر، ومعانقة أمواجه، وكأن فلسطين خرجت من حزنها، واستعادت ذاتها، فننسى أن ثمة محتلاً، وهذا يتضح عندما يتجاهل ثريا وعماد الغرباء من حولهم على شاطئ البحر، فيتصرفان كأنهما جزء أصيل من المكان، فلزمن ما تناسيا أنهما تحت الاحتلال، وأنهما من وجهة نظر القانون متسللين أو لصوصاً.
ما يميز هذه المشاهد اعتمادها على توليد طاقة مركزها الانغماس في المشهدية، التي يتقن الممثلان تجسيدها، وهنا نصل إلى العنصر الثالث، وأعني توظيف الموسيقى التصويرية والأغاني المواكبة لبعض المشاهد، فتمتزج العناصر الثلاثة مع أداء الممثلين، اللذين يتقنان الصمت في بعض المشاهد بغية إتاحة فرصة للمشاهد لأن يتأمل حضرة المكان، دون تشويش أو حشو لا قيمة دلالية له.
في مشهد يشي بالكثير، يمضي الثنائي إلى قرية الدوايمة ليعيشا في فسحة خارج الزمن، في أطلال مكان تاريخي، حيث يكونان حلم بيت في مكانهما الطبيعي، وفي هذا السياق تتكئ المخرجة على فعل تصوير المكان، بعدسة شديدة التميز والشاعرية، حيث تمتزج معاناة الفلسطيني بحضور المستوطنات، والجدار، والطبيعة، والسلب، وثقل التاريخ، وهكذا تبدو المشاهد متشابكة ومتداخلة، لكنها تقيم نوعاً من الغضب، ولاسيما ونحن نشاهد عماد وثريا وهما يتشوفان يافا من خلف الجبل والمستوطنات التي تقطع الامتداد الطبيعي للنظر، ولفلسطين، وللتاريخ، وللزمن.
حين ينتقل عماد وثريا للداخل نقرأ في سلوكهما فعلاً متعالياً لتجاوز إشكاليات التعريف، ومفهوم الحق، حيث يعدّان فلسطين مجالاً طبيعياً لهما، هي الحق، ولهذا يقطفان حبات البرتقال من الشوارع، وكأن فعل الاستلاب قد تعطل، مع تساؤلات يجسدها الحوار، حين يصرخ عماد بثريا قائلاً: بتفكري فلسطين برتقال… شو يعني فلسطين؟ هكذا نواجه أسئلتنا في اختزال هذا المكون برمزية لا تبدو لنا سوى حالة شعرية تحتمل الكثير من علامات الاستفهام، وفي حوار آخر تستدعي ثريا ماذا كان يفعل جدها وجدتها في يافا قبل النكبة، حيث تذكر أسماء الشوارع، وذهابهما إلى سينما الحمراء، في سرد متوتر، لنخلص إلى مقولة إن الحياة قد سرقت من الفلسطينيين، هكذا يتوقف الفيلم لمناقشة هذا الاستلاب أو السرقة التي تتقاطع مع بنية المكان والتاريخ والزمن والحلم، مع أنها بدأت من مبلغ 150 جنيها لكنها شكلت مفارقة أو مركزاً خطابياً أو منطلقاً لقراءة معنى الخسران لعالم كان جميلاً، ولم يبق لنا سوى ملح البحر الذي تحول إلى إحساس ما، ينضح بالتناقض في معرفة ذواتنا، والمكان والزمن.
لقد اتقنت المخرجة تعميق مشاهد للبحر ببلاغة مشهدية، كما استطاعت أن تخترق وعي المشاهد، لتحميله طاقة انفعالية عميقة، فلا جرم في أن يطرح سؤال الشخصيات عن شعور الأنا، وهي تعود إلى المكان أو فلسطين؟ إنه سؤال نتوقعه لو أتيحت لنا العودة، لقد استبقت المخرجة وعي الفلسطيني في رمزية عودة ثريا، في حين تملكت ما يمكن أن يتداعى في وعينا عند العودة، عبر مشهد متشنج عندما يلقى القبض على ثريا وعماد، فتقوم قوات الاحتلال بترحيلها، وهكذا تواجه ثريا الاستجواب عينه الذي بدأ في المشهد الافتتاحي، لكن تتغير الإجابات لتحمل عبارات: ولدت هنا، وأنا من هنا.. لينتهي الفيلم الذي صنع لتخليد ذكرى قرية الدوايمة، التي أمست أطلالاً لم يبق لها أثر، هكذا يبدو هذا الفيلم بوصفه محاولة للكتابة فوق التاريخ الذي نسخ تاريخاً آخر، ينبغي أن يستعاد. إنها لعبة خطابية تسعى لأن تجعل لغة الفرد، الفلسطيني وهو يتخطى حدود الخطابات المؤسساتية، وأعراف عقلانية الساسة، وتفاهمات الدول.
رامي ابو شهاب